تعاني بريطانيا من واحد من تشنجاتها المتكررة الناجمة عن السخط الأخلاقي. فقد وُجِدَ سياسيون وأساتذة متلبسين في حالة من التناغم مع طاغية. وكما يمكن أن يقول دونالد رامسفيلد، هذه الأمور تحدث. فالوحش الفاشستي اليوم من المحتمل أن يكون في النهاية المستبد نصف المحترم غداً. وتبرز المشكلة، كما هو واضح بخصوص معمر القذافي، حين ينعكس اتجاه المسار.
ما يبعث على الحيرة هو أن الجميع أصيبوا بالصدمة من الشبكة التي حيكت بين المؤسسة السياسية والمالية البريطانية من جهة والطاغية الليبي وأسرته من الجهة الأخرى. وسبق لديفيد ميليباند، وزير الخارجية السابق، أن وصف بريطانيا بأنها مركز عالمي وتقاطع ملائم للاستثمارات والتجارة والأشخاص المتحركين حول العالم. وأنا أفضل وصفها بأنها مغسلة عالمية.

فيما يتعلق بالورطة مع القذافي يتم تكديس اللوم على كتفي توني بلير. ولا جديد في هذا. وبلغت عداوة وسائل إعلام المدن، على سعتها، تجاه رئيس الوزراء الأسبق درجة اعتباره في إحدى اللحظات متدخلاً ساذجاً في السياسة الخارجية، وفي لحظة تالية واقعياً متشككا.
للفضيحة الليبية سوابق أعمق بكثير. فقد كانت لندن منذ فترة طويلة مركزاً لغسل الثروات والسمعات الأجنبية – مكان يودع فيه المستبدون وحكام القلة أموالهم ويلمعون فيه صورهم طالما ظلوا، بالطبع، قادرين على تحمل دفع الرسوم المرتفعة.
إن اهتمام المصرفيين الأذكياء، والمحاسبين المبدعين، ومسؤولي العلاقات العامة الرقيقين، ينتزع إعجابا شديدا. وإذا أضفنا إلى ذلك مظهر الاحترام الناتج عن الارتباط الذي يقدمه بعض أكثر مؤسسات العالم مهابة – جامعات عريقة، متاحف مشهورة، وصالات لعرض الأعمال الفنية، ومن المحزن القول كذلك، العضو الغريب في العائلة الملكية – فإن عنصر الجاذبية لا يمكن مقاومته.
القرار المبدئي بالانخراط مع العقيد القذافي كان عملا مقبولا، وإن كان بغيضا، من أعمال السياسة الخارجية. فإذا كانت ليبيا مستعدة للتخلي عن برامجها للأسلحة غير التقليدية وقطع التمويل عن الإرهابيين، إذا ذوبان جليد العلاقات يصبح ثمنا يستحق الدفع.
لكن انحرفت الأمور حين تم توسيع السياسة الواقعية لتشمل جانب الأعمال – عندما حلّ بلير في خيمة العقيد القذافي كمدير مبيعات في شركات نفطية وشركات سلاح. وتم نسيان الأخلاق بمجرد أن فتح الزعيم الليبي، وابنه سيف، دفتري شيكاتهما.
وفي هذا رسالة إلى ديفيد كاميرون. فقد جعل رئيس الوزراء تشجيع التجارة أولويته الأولى على صعيد السياسة الخارجية. وقام خلال الفترة الأخيرة بجولة على دول الخليج رافقه فيها أكبر مصدري الأسلحة. وبدا لبعضهم أن هذا الأمر لم يكن الإشارة الصحيحة التي يمكن إرسالها في وقت اليقظة الديمقراطية في الشرق الأوسط.
فضيحة التعامل مع القذافي كلفت مدرسة لندن للعلوم الاقتصادية، وهي واحدة من أكثر مراكز المعرفة احتراماً في بريطانيا، خسارة مديرها. اعترف السير هووارد ديفيز الذي ترك منصبه بارتكابه أخطاء في تقدير الأمور. مع ذلك، الأخطاء لم تكن مفاجئة. فالمنح الجامعية احتلت المرتبة الثانية لبعض الوقت في مدرسة لندن للعلوم الاقتصادية، مع السعي إلى الحصول على الرسوم الجامعية من الطلبة الأجانب والوصول إلى ثروات آبائهم وأمهاتهم.
وعلى أية حال، مدرسة لندن للعلوم الاقتصادية ليست وحدها التي التمست هبات كبرى من جهات خيرية خارجية، مع – كيف للمرء أن يصيغ ذلك؟ - مجرد تقيُّد غير مبال بأخلاقيات الأعمال أو القيم الجامعية. وتعد جامعتا أكسفورد وكامبردج متلقيتان تواقتان لمثل هذه العطايا.
إن ما تمثله بريطانيا، إذا شئت، هو مغسلة تدار بوضع قطع العملات في فتحات معينة من جانب من يواجهون تحديات تتعلق بسمعتهم. وإذا ذهبت إلى مايفير ونايتسبردج (تفكّر في تلك الشقق الحقيرة التي بيعت خلال الفترة الأخيرة بالقرب من هايد بارك) حيث توفر أوكاراً سيئة للإقامة تحت اسم الاستثمارات الذكية. والبنوك الخاصة وصناديق التحوط في شارع سانت جيمس القريب من ذلك، موجودة ومستعدة لتقديم الاستشارات المالية، مع ضمان السرية.
بالقامة ذاتها، يقف إلى جانب مستشاري العقارات والاستثمارات مستشارو العلاقات العامة مرتفعو الأجور. ولا يتفوق عليهم أحد في مهارة شرح كيف أن ذلك الطاغية الإفريقي قد أسيء فهمه، أو تقديم أكثر أصحاب المليارات الأجانب بعثاً للشك في النفوس على أنه راعٍ سخي للفنون.
فمن هم أبرز زبائن هذه الصناعة المزدهرة؟ ومن هم الذين يقفون وراء شركات القواقع التي تمتلك معظم عقارات لندن السكنية؟ ومن أين جاءت هذه الأموال؟
لا نستطيع الجزم. وهنا تكمن الحقيقة المفحمة المطلقة. وبالإضافة إلى ويمبلدون، وهنيلي، وآسكوت، وغير ذلك من الملطفات الاجتماعية وحفلات الصيد والمدارس الداخلية المشهورة، فإن لدى بريطانيا سلاحاً آخر.
إنه يأتي في صورة قوانين تشهيرية فظيعة. وغني عن القول أن هناك مجموعة من المحامين الذين هم على استعداد للتأكيد على أن حماية المحاكم متوافرة لأي شخص لديه من الأموال ما يكفي لدفع رسومها شديدة الارتفاع.
لقد تم تكميم أفواه وسائل الإعلام. والحفر عميقاً في صفقات المليارديرات المتجولين والطغاة الأجانب يجلب إليك تحدياً قانونياً. ويطالب القانون الصحافيين بأدلة دامغة على وجود صفقات تبعث على الريبة. وهذا أمر يصعب الحصول عليه في براري الاتحاد السوفياتي السابق، أو العالم المغلق للاستبداديين في أماكن أخرى. ولذلك، على الرغم من موجات السخط من حين إلى آخر، فإن بريطانيا تهز كتفيها وتمضي في عمليات الغسيل. إنه أمر باعث على خيبة الأمل بالفعل، لكنه مرة أخرى مدر لأرباح كبرى.
FX-Arabia
|
|
جديد المواضيع |

لوحة التحكم
روابط هامة
|
||||||
| استراحة اف اكس ارابيا استرح هنا و انسى عناء السوق و التداول |
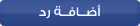 |
|
|
أدوات الموضوع |
|
|
المشاركة رقم: 1 | ||||||||||||||||||||||
|
المنتدى :
استراحة اف اكس ارابيا
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
#1
|
|
|
|
|
تعاني بريطانيا من واحد من تشنجاتها المتكررة الناجمة عن السخط الأخلاقي. فقد وُجِدَ سياسيون وأساتذة متلبسين في حالة من التناغم مع طاغية. وكما يمكن أن يقول دونالد رامسفيلد، هذه الأمور تحدث. فالوحش الفاشستي اليوم من المحتمل أن يكون في النهاية المستبد نصف المحترم غداً. وتبرز المشكلة، كما هو واضح بخصوص معمر القذافي، حين ينعكس اتجاه المسار.
ما يبعث على الحيرة هو أن الجميع أصيبوا بالصدمة من الشبكة التي حيكت بين المؤسسة السياسية والمالية البريطانية من جهة والطاغية الليبي وأسرته من الجهة الأخرى. وسبق لديفيد ميليباند، وزير الخارجية السابق، أن وصف بريطانيا بأنها مركز عالمي وتقاطع ملائم للاستثمارات والتجارة والأشخاص المتحركين حول العالم. وأنا أفضل وصفها بأنها مغسلة عالمية.  فيما يتعلق بالورطة مع القذافي يتم تكديس اللوم على كتفي توني بلير. ولا جديد في هذا. وبلغت عداوة وسائل إعلام المدن، على سعتها، تجاه رئيس الوزراء الأسبق درجة اعتباره في إحدى اللحظات متدخلاً ساذجاً في السياسة الخارجية، وفي لحظة تالية واقعياً متشككا. للفضيحة الليبية سوابق أعمق بكثير. فقد كانت لندن منذ فترة طويلة مركزاً لغسل الثروات والسمعات الأجنبية – مكان يودع فيه المستبدون وحكام القلة أموالهم ويلمعون فيه صورهم طالما ظلوا، بالطبع، قادرين على تحمل دفع الرسوم المرتفعة. إن اهتمام المصرفيين الأذكياء، والمحاسبين المبدعين، ومسؤولي العلاقات العامة الرقيقين، ينتزع إعجابا شديدا. وإذا أضفنا إلى ذلك مظهر الاحترام الناتج عن الارتباط الذي يقدمه بعض أكثر مؤسسات العالم مهابة – جامعات عريقة، متاحف مشهورة، وصالات لعرض الأعمال الفنية، ومن المحزن القول كذلك، العضو الغريب في العائلة الملكية – فإن عنصر الجاذبية لا يمكن مقاومته. القرار المبدئي بالانخراط مع العقيد القذافي كان عملا مقبولا، وإن كان بغيضا، من أعمال السياسة الخارجية. فإذا كانت ليبيا مستعدة للتخلي عن برامجها للأسلحة غير التقليدية وقطع التمويل عن الإرهابيين، إذا ذوبان جليد العلاقات يصبح ثمنا يستحق الدفع. لكن انحرفت الأمور حين تم توسيع السياسة الواقعية لتشمل جانب الأعمال – عندما حلّ بلير في خيمة العقيد القذافي كمدير مبيعات في شركات نفطية وشركات سلاح. وتم نسيان الأخلاق بمجرد أن فتح الزعيم الليبي، وابنه سيف، دفتري شيكاتهما. وفي هذا رسالة إلى ديفيد كاميرون. فقد جعل رئيس الوزراء تشجيع التجارة أولويته الأولى على صعيد السياسة الخارجية. وقام خلال الفترة الأخيرة بجولة على دول الخليج رافقه فيها أكبر مصدري الأسلحة. وبدا لبعضهم أن هذا الأمر لم يكن الإشارة الصحيحة التي يمكن إرسالها في وقت اليقظة الديمقراطية في الشرق الأوسط. فضيحة التعامل مع القذافي كلفت مدرسة لندن للعلوم الاقتصادية، وهي واحدة من أكثر مراكز المعرفة احتراماً في بريطانيا، خسارة مديرها. اعترف السير هووارد ديفيز الذي ترك منصبه بارتكابه أخطاء في تقدير الأمور. مع ذلك، الأخطاء لم تكن مفاجئة. فالمنح الجامعية احتلت المرتبة الثانية لبعض الوقت في مدرسة لندن للعلوم الاقتصادية، مع السعي إلى الحصول على الرسوم الجامعية من الطلبة الأجانب والوصول إلى ثروات آبائهم وأمهاتهم. وعلى أية حال، مدرسة لندن للعلوم الاقتصادية ليست وحدها التي التمست هبات كبرى من جهات خيرية خارجية، مع – كيف للمرء أن يصيغ ذلك؟ - مجرد تقيُّد غير مبال بأخلاقيات الأعمال أو القيم الجامعية. وتعد جامعتا أكسفورد وكامبردج متلقيتان تواقتان لمثل هذه العطايا. إن ما تمثله بريطانيا، إذا شئت، هو مغسلة تدار بوضع قطع العملات في فتحات معينة من جانب من يواجهون تحديات تتعلق بسمعتهم. وإذا ذهبت إلى مايفير ونايتسبردج (تفكّر في تلك الشقق الحقيرة التي بيعت خلال الفترة الأخيرة بالقرب من هايد بارك) حيث توفر أوكاراً سيئة للإقامة تحت اسم الاستثمارات الذكية. والبنوك الخاصة وصناديق التحوط في شارع سانت جيمس القريب من ذلك، موجودة ومستعدة لتقديم الاستشارات المالية، مع ضمان السرية. بالقامة ذاتها، يقف إلى جانب مستشاري العقارات والاستثمارات مستشارو العلاقات العامة مرتفعو الأجور. ولا يتفوق عليهم أحد في مهارة شرح كيف أن ذلك الطاغية الإفريقي قد أسيء فهمه، أو تقديم أكثر أصحاب المليارات الأجانب بعثاً للشك في النفوس على أنه راعٍ سخي للفنون. فمن هم أبرز زبائن هذه الصناعة المزدهرة؟ ومن هم الذين يقفون وراء شركات القواقع التي تمتلك معظم عقارات لندن السكنية؟ ومن أين جاءت هذه الأموال؟ لا نستطيع الجزم. وهنا تكمن الحقيقة المفحمة المطلقة. وبالإضافة إلى ويمبلدون، وهنيلي، وآسكوت، وغير ذلك من الملطفات الاجتماعية وحفلات الصيد والمدارس الداخلية المشهورة، فإن لدى بريطانيا سلاحاً آخر. إنه يأتي في صورة قوانين تشهيرية فظيعة. وغني عن القول أن هناك مجموعة من المحامين الذين هم على استعداد للتأكيد على أن حماية المحاكم متوافرة لأي شخص لديه من الأموال ما يكفي لدفع رسومها شديدة الارتفاع. لقد تم تكميم أفواه وسائل الإعلام. والحفر عميقاً في صفقات المليارديرات المتجولين والطغاة الأجانب يجلب إليك تحدياً قانونياً. ويطالب القانون الصحافيين بأدلة دامغة على وجود صفقات تبعث على الريبة. وهذا أمر يصعب الحصول عليه في براري الاتحاد السوفياتي السابق، أو العالم المغلق للاستبداديين في أماكن أخرى. ولذلك، على الرغم من موجات السخط من حين إلى آخر، فإن بريطانيا تهز كتفيها وتمضي في عمليات الغسيل. إنه أمر باعث على خيبة الأمل بالفعل، لكنه مرة أخرى مدر لأرباح كبرى. |
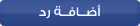 |
| مواقع النشر (المفضلة) |
| الكلمات الدلالية (Tags) |
| مغسلة, الطغاة, بريطانيا, خدمة |
|
|
الساعة الآن 09:24 AM











