في عام 2002، أعطيت إذنا بنشر العنوان غير المسيء، كما هو واضح، لـ ''تقرير التنمية البشرية العربية''. وفي غضون أيام من نشره تم تحميل ملايين النسخ من طبعته العربية، وكانت قناة ''الجزيرة'' الجديدة آنئذ، تتداوله دون توقف. وبعد فترة قصيرة أدان اجتماع وزاري مغلق لجامعة الدول العربية دعوة التقرير إلى نشر الديمقراطية، وحقوق المرأة، والتعليم غير الديني – وتحذيراته بشأن تأخر المنطقة والبطالة بين الشباب. وكانت المنطقة هادئة حتى حينما اجتاحت العملية الديمقراطية والتحرير الاقتصادي قسماً كبيراً من باقي العالم.
تقودني حياتي المهنية، بوصفي مستشارا سياسيا لقوى المعارضة الديمقراطية المتمردة، إلى ثلاثة دروس عند هذه المرحلة من الطوفان الذي يجتاح العالم العربي. أولاً، كان يجب أن تحدث الثورة في وقت أبكر. وثانياً، لم تحدث لأن بلدانا مثل ليبيا ومصر كانت دولا أمنية لم تكن تسمح للمعارضة بأن تنمو. وسيكون هذا الآن بمثابة عائق. وأخيرا، سيكون للولايات المتحدة دور أكبر بكثير، رغم أنه غير متساو، في توجيه هذه البلدان خلال صراعاتها الحالية، ثم في المرحلة الانتقالية بعدئذ، خلافاً لما هو معترف به على نحو شائع.
حينما وجدت نفسي في مواجهة وزراء الجامعة العربية الغاضبين، كنت أشغل منصب رئيس ذراع التنمية في الأمم المتحدة. وكانت قد كتبت تقريرنا مجموعة من خبراء السياسة العرب، وبالتالي كنا بريئين من تهمة التدخل الغربي. ولأنني كنت على رأس وكالة للتنمية تبلغ ميزانيتها عدة مليارات من الدولارات، فإنني رغم ذلك كنت يائساً من إحداث أي تغيير في المنطقة العربية ما لم يكن باستطاعتنا تحفيز ثورة فكرية. فقد كان الشعب سجين إقطاعيات من الأفكار والسياسات التي قيدت حياته الوطنية.
بناءً عليه، تعتبر أحداث الأسابيع الأخيرة مدعاة للاحتفال. إنها فعلياً ثورة عربية. لكن في أفضل الأحوال، هذه مجرد بداية لتحرير العقول والناس. ففي تونس ومصر، فإن عقوداً من حقوق العمال المقموعة والظلم الاجتماعي تندفع إلى السطح. وعلى الأرجح أن يعود الحكام الانتقاليون إلى العادات القديمة ويفضلون الاستقرار على فوضى الديمقراطية.
ستنمو المخاوف حول ما إذا كانت الأنظمة الجديدة في مصر وفي أماكن أخرى ستضر بالعلاقات مع إسرائيل والولايات المتحدة. ومع ذلك، فإن خبرتي هي أن العلاقات الخارجية تبقى في العادة دون تغيير إلى حد كبير في أعقاب مثل تلك الأحداث. فحينما دفعت كوري أكينو، الرئيس فيرديناند ماركوس، خارج السلطة في الفلبين عام 1986، هددت بطرد القواعد العسكرية الأمريكية. وكانت النتيجة تخفيضا متفقا عليه بين الجانبين للوجود الأمريكي، ساهم في خدمة الحكومتين على نحو جيد.
ستبقى مصر راغبة في علاقات ثلاثية الأطراف مع إسرائيل وفلسطين، وستكون للجيش كلمة قوية في هذا الصدد، وعلى الأرجح أن تبقى الولايات المتحدة الحليف غير الإقليمي المهم، حتى لو استخدمت حكومة مصرية ديمقراطية لهجة خطابية أكثر حدة. وسيكون المكسب الكبير هو أن الحكومة الديمقراطية ستكون قادرة على الأرجح على اتخاذ المخاطر من أجل السلام، بخلاف سلفها الاستبدادي. ورغم كل شيء، ستحظى بتفويض شعبي.
غير أن القصة مختلفة تماماً على الجبهة الداخلية. هنا المخاطر ليست كما حدث في إيران عام 1979، وإنما كما حدث في الفلبين عام 1986، أو في أمريكا اللاتينية خلال ثمانينيات القرن الماضي، أو أوروبا الشرقية عام 1989. وفي معظم هذه الحالات برهنت الحكومات الديمقراطية في النهاية على أنها ضعيفة مبدئياً، وفي كثير من الأحيان غير قادرة على الدفع قدماً بالإصلاحات الاقتصادية التي كان من الممكن أن تجلب الرفاه إلى أولئك الذين صوتوا لها.
وكان السبب في ذلك أن مجموعة من العمال والناشطين الاجتماعيين، والليبراليين الاقتصاديين، وأولئك المعارضين سياسياً، اجتمعوا معاً للتخلص من شيء كانوا يعرفون أنهم يعارضونه – سواء كان ماركوس، أو قادة أمريكا اللاتينية المختلفين، أو كبار أعضاء الحزب الشيوعي من ذوي الذقون السمينة. وحالما تم تحقيق ذلك، تلاشى اتفاقهم ببساطة. كانوا يعرفون ماذا يعارضون، لكن ليس لماذا هم موجودون.
والدرس الأخير بالنسبة للمنطقة هو أنه رغم كل الحديث عن أن أفضل سنوات أمريكا تصبح خلفها الآن، إلا أن هذه الأزمة تؤكد على نحو ما كيف أن دور واشنطن بالأهمية ذاتها التي كان عليها خلال كل ثورة ديمقراطية حدثت خلال الأعوام الـ 30 الماضية. على الأرجح ألا تكون سمعتها جيدة لدى المحتجين، لكن قدرة الولايات المتحدة على أن تقول للنظام المصري إنه حان الوقت للرحيل وتساعد بعدئذ في توجيه المرحلة الانتقالية ليس لها نظير.
والآمال الكبيرة متعلقة بليبيا، وكذلك سورية وإيران، في حال اشتدت قبضة المحتجين. ومن الواضح أن المرسوم الأمريكي لا يسري هنا. ومع ذلك تتمحور القيادة الآن بشكل مباشر حول الرئيس باراك أوباما ليقوم بأمرين تعارضهما واشنطن إلى حد كبير. فما حاول فعله في خطابه في القاهرة بعد مرور ستة أشهر على قدومه إلى البيت الأبيض، يمكن تحقيقه الآن. وبإمكانه أن يبدأ في إزالة التشوهات عن علامة أمريكا، بجعلها تأخذ جانب التغيير الديمقراطي. لكن بوجود أنظمة مثل نظام العقيد معمر القذافي، فإن ذلك يعني عملية مؤلمة (و مثيرة للخلاف بالنسبة إلى الكونغرس الأمريكي) تتمثل في العمل من خلال الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية المكروهتين، لبناء إجماع شرعي متعدد الأطراف لعزله والضغط عليه للإذعان.
إنها إحدى اللحظات العالمية التي يتعين خلالها على رئيس أمريكي أن ينحاز إلى أحد الأطراف. وحين تساوره الشكوك، أو حين يدفعه الكونغرس أو وزارة الخارجية إلى التراجع، عليه أن يفكر في شجاعة المحتجين الليبيين وطموحات جيل من الشباب العرب الذين جعلوا هذه اللحظة ممكنة.
الكاتب مستشار سياسي دولي سابق، ونائب سابق للأمين العام للأمم المتحدة، ومؤلف كتاب The Unfinished Global Revolution
FX-Arabia
|
|
جديد المواضيع |

لوحة التحكم
روابط هامة
|
||||||
| منتدى الاخبار و التحليل الاساسى تعرض فيه الاخبار المتجددة لحظيا و التحليل الاساسى و تحليلات الشركات المختلفة للاسواق, اخبار فوركس,اخبار السوق,بلومبيرج,رويترز,تحليلات فوركس ، تحليل فنى ، اخر اخبار الفوركس ، اخبار الدولار ، اخبار اليورو ، افضل موقع تحليل ، اخبار السوق ، اخبار البورصة ، اخبار الفوركس ، اخبار العملات ، تحليلات فنية يومية ، تحليل يورو دولار |
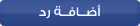 |
|
|
أدوات الموضوع |
|
|
المشاركة رقم: 1 | ||||||||||||||||||||||
|
المنتدى :
منتدى الاخبار و التحليل الاساسى
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
#1
|
|
|
|
|
في عام 2002، أعطيت إذنا بنشر العنوان غير المسيء، كما هو واضح، لـ ''تقرير التنمية البشرية العربية''. وفي غضون أيام من نشره تم تحميل ملايين النسخ من طبعته العربية، وكانت قناة ''الجزيرة'' الجديدة آنئذ، تتداوله دون توقف. وبعد فترة قصيرة أدان اجتماع وزاري مغلق لجامعة الدول العربية دعوة التقرير إلى نشر الديمقراطية، وحقوق المرأة، والتعليم غير الديني – وتحذيراته بشأن تأخر المنطقة والبطالة بين الشباب. وكانت المنطقة هادئة حتى حينما اجتاحت العملية الديمقراطية والتحرير الاقتصادي قسماً كبيراً من باقي العالم.
تقودني حياتي المهنية، بوصفي مستشارا سياسيا لقوى المعارضة الديمقراطية المتمردة، إلى ثلاثة دروس عند هذه المرحلة من الطوفان الذي يجتاح العالم العربي. أولاً، كان يجب أن تحدث الثورة في وقت أبكر. وثانياً، لم تحدث لأن بلدانا مثل ليبيا ومصر كانت دولا أمنية لم تكن تسمح للمعارضة بأن تنمو. وسيكون هذا الآن بمثابة عائق. وأخيرا، سيكون للولايات المتحدة دور أكبر بكثير، رغم أنه غير متساو، في توجيه هذه البلدان خلال صراعاتها الحالية، ثم في المرحلة الانتقالية بعدئذ، خلافاً لما هو معترف به على نحو شائع. حينما وجدت نفسي في مواجهة وزراء الجامعة العربية الغاضبين، كنت أشغل منصب رئيس ذراع التنمية في الأمم المتحدة. وكانت قد كتبت تقريرنا مجموعة من خبراء السياسة العرب، وبالتالي كنا بريئين من تهمة التدخل الغربي. ولأنني كنت على رأس وكالة للتنمية تبلغ ميزانيتها عدة مليارات من الدولارات، فإنني رغم ذلك كنت يائساً من إحداث أي تغيير في المنطقة العربية ما لم يكن باستطاعتنا تحفيز ثورة فكرية. فقد كان الشعب سجين إقطاعيات من الأفكار والسياسات التي قيدت حياته الوطنية. بناءً عليه، تعتبر أحداث الأسابيع الأخيرة مدعاة للاحتفال. إنها فعلياً ثورة عربية. لكن في أفضل الأحوال، هذه مجرد بداية لتحرير العقول والناس. ففي تونس ومصر، فإن عقوداً من حقوق العمال المقموعة والظلم الاجتماعي تندفع إلى السطح. وعلى الأرجح أن يعود الحكام الانتقاليون إلى العادات القديمة ويفضلون الاستقرار على فوضى الديمقراطية. ستنمو المخاوف حول ما إذا كانت الأنظمة الجديدة في مصر وفي أماكن أخرى ستضر بالعلاقات مع إسرائيل والولايات المتحدة. ومع ذلك، فإن خبرتي هي أن العلاقات الخارجية تبقى في العادة دون تغيير إلى حد كبير في أعقاب مثل تلك الأحداث. فحينما دفعت كوري أكينو، الرئيس فيرديناند ماركوس، خارج السلطة في الفلبين عام 1986، هددت بطرد القواعد العسكرية الأمريكية. وكانت النتيجة تخفيضا متفقا عليه بين الجانبين للوجود الأمريكي، ساهم في خدمة الحكومتين على نحو جيد. ستبقى مصر راغبة في علاقات ثلاثية الأطراف مع إسرائيل وفلسطين، وستكون للجيش كلمة قوية في هذا الصدد، وعلى الأرجح أن تبقى الولايات المتحدة الحليف غير الإقليمي المهم، حتى لو استخدمت حكومة مصرية ديمقراطية لهجة خطابية أكثر حدة. وسيكون المكسب الكبير هو أن الحكومة الديمقراطية ستكون قادرة على الأرجح على اتخاذ المخاطر من أجل السلام، بخلاف سلفها الاستبدادي. ورغم كل شيء، ستحظى بتفويض شعبي. غير أن القصة مختلفة تماماً على الجبهة الداخلية. هنا المخاطر ليست كما حدث في إيران عام 1979، وإنما كما حدث في الفلبين عام 1986، أو في أمريكا اللاتينية خلال ثمانينيات القرن الماضي، أو أوروبا الشرقية عام 1989. وفي معظم هذه الحالات برهنت الحكومات الديمقراطية في النهاية على أنها ضعيفة مبدئياً، وفي كثير من الأحيان غير قادرة على الدفع قدماً بالإصلاحات الاقتصادية التي كان من الممكن أن تجلب الرفاه إلى أولئك الذين صوتوا لها. وكان السبب في ذلك أن مجموعة من العمال والناشطين الاجتماعيين، والليبراليين الاقتصاديين، وأولئك المعارضين سياسياً، اجتمعوا معاً للتخلص من شيء كانوا يعرفون أنهم يعارضونه – سواء كان ماركوس، أو قادة أمريكا اللاتينية المختلفين، أو كبار أعضاء الحزب الشيوعي من ذوي الذقون السمينة. وحالما تم تحقيق ذلك، تلاشى اتفاقهم ببساطة. كانوا يعرفون ماذا يعارضون، لكن ليس لماذا هم موجودون. والدرس الأخير بالنسبة للمنطقة هو أنه رغم كل الحديث عن أن أفضل سنوات أمريكا تصبح خلفها الآن، إلا أن هذه الأزمة تؤكد على نحو ما كيف أن دور واشنطن بالأهمية ذاتها التي كان عليها خلال كل ثورة ديمقراطية حدثت خلال الأعوام الـ 30 الماضية. على الأرجح ألا تكون سمعتها جيدة لدى المحتجين، لكن قدرة الولايات المتحدة على أن تقول للنظام المصري إنه حان الوقت للرحيل وتساعد بعدئذ في توجيه المرحلة الانتقالية ليس لها نظير. والآمال الكبيرة متعلقة بليبيا، وكذلك سورية وإيران، في حال اشتدت قبضة المحتجين. ومن الواضح أن المرسوم الأمريكي لا يسري هنا. ومع ذلك تتمحور القيادة الآن بشكل مباشر حول الرئيس باراك أوباما ليقوم بأمرين تعارضهما واشنطن إلى حد كبير. فما حاول فعله في خطابه في القاهرة بعد مرور ستة أشهر على قدومه إلى البيت الأبيض، يمكن تحقيقه الآن. وبإمكانه أن يبدأ في إزالة التشوهات عن علامة أمريكا، بجعلها تأخذ جانب التغيير الديمقراطي. لكن بوجود أنظمة مثل نظام العقيد معمر القذافي، فإن ذلك يعني عملية مؤلمة (و مثيرة للخلاف بالنسبة إلى الكونغرس الأمريكي) تتمثل في العمل من خلال الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية المكروهتين، لبناء إجماع شرعي متعدد الأطراف لعزله والضغط عليه للإذعان. إنها إحدى اللحظات العالمية التي يتعين خلالها على رئيس أمريكي أن ينحاز إلى أحد الأطراف. وحين تساوره الشكوك، أو حين يدفعه الكونغرس أو وزارة الخارجية إلى التراجع، عليه أن يفكر في شجاعة المحتجين الليبيين وطموحات جيل من الشباب العرب الذين جعلوا هذه اللحظة ممكنة. الكاتب مستشار سياسي دولي سابق، ونائب سابق للأمين العام للأمم المتحدة، ومؤلف كتاب The Unfinished Global Revolution |
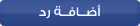 |
| مواقع النشر (المفضلة) |
| الكلمات الدلالية (Tags) |
| لأمريكا, نادرة, لترميم, صورتها, فرصة |
|
|
الساعة الآن 09:45 PM











