وكانت الأزمات السابقة قد مهدت الطريق أمام تغيرات بنيوية، أو على أقل تقدير، ساهمت في تسريع وتيرة هذه التغيرات. كما ساهمت الأزمات بتنظيم مؤسسات الدولة، ودولة الرفاه بالذات، وليس أقله النموذج الاقتصادي الكينزي الذي هيمن لفترة طويلة على النهج الاقتصادي. وكانت هذه الصورة الأكبر، لكن، في النهاية، انفصلت " التأثيرات الإيجابية المنتجة " مجددا عن مجموعة المصالح القوية، وتم التضييق عليها في ألمانيا من قبل ائتلاف الحزبين الديمقراطي الاشتراكي والخضر، الذي ألغى الأنظمة القائمة وتخلى عن مستوى توزيع الدخل الذي أمكن تحقيقه، مما شكل أحد أسباب الصدمة الاقتصادية الحالية.
فهل تم استيعاب دروس أزمة الدين في أوروبا؟ لا يبدو ذلك. فما يجري تمريره للجمهور الأوروبي باعتباره شكل لإدارة الأزمة لا علاقة له ب "التأثيرات المنتجة الإيجابية" التي تحدث عنها كوكا، وبدلا من إيجاد حل لأسباب الأزمة الاقتصادية والسياسية، فإن هذه الأسباب يجري التعامل معها على أنها هي الحل، وما تبقى للدولة من دور منذ عام 2008، يتلخص في تحمل الأعباء الاجتماعية لتلك الأزمة المالية العائدة للقطاع الخاص. وما ان أصبحت الميزانيات العامة تنوء تحت وطأة كلفة توالد الثروات الخاصة، حتى تم صرف وصفة جديدة للشفاء من المرض الذي بات يدعى الآن "أزمة الدولة
ومع انتشار الأزمة، انتقل المبدأ الألماني القاضي "بكبح الدين" إلى أوروبا. لكن هل هذا بفضل فضائل ربة المنزل المقتصدة كما تدعي المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل؟ لا بتاتا، وميركل تقول: "ما يتوجب عدم القيام به هو تدمير ثقة المستثمرين، فيما نحن نسعى إلى إيجاد حلول"، وهذا يكشف عن ولائها، ويوضح المستوى الذي وصل إليه الجدال الأوروبي، حيث بات يقتصر على توفير المال والمحافظة على حق المطالبة بالديون وعلى التنافسية، وعندما تجري المطالبة بمزيد من «العاطفة تجاه أوروبا»، ينحسر الجدل في الدعوة إلى عقوبة ضبط الميزانيات، وسن قوانين لسداد الديون السيادية، وغيرها. وكل هذا لا يمكنه إخفاء المشاحنات ذات الأبعاد السياسية للائتلاف الحاكم في ألمانيا حيال السياسة الأوروبية. والحديث عن أن البرلمان في المستقبل سيصبح على علاقة وثيقة بالقرارات المتعلقة بإنقاذ اليورو، لا يشكل بحد ذاته جوابا على السؤال حول ماذا سيقوم النواب بإنقاذه أصلا.
أخيرا، أعلنت المستشارة الألمانية: «إذا فشل اليورو، فشلت أوروبا». والجملة في افضل الأحوال تعبر عن نصف الحقيقة، لان الأسس التي قامت عليها أوروبا بشكلها الأفضل قد تم تدميرها، فأوروبا التي كانت في نزاع حول معاهدة لشبونة، كانت على الأقل مفتوحة للنقاش، كانت تقف إلى جانب المعايير الاجتماعية والحقوق الأساسية القابلة للتنفيذ. ومن يريد إنقاذ أوروبا، وفي ذهنه اكثر من مجرد مشروع نخبوي من منطلق مصلحة اقتصادية لا غير، يصاحبها بالتأكيد عجز ديمقراطي ومنافسة ضريبية وإغراق بالعمالة الرخيصة، يتوجب عليه ان يقف الآن للدفاع عن نفسه ضد هجمات المنقذين أمثال المستشارة ميركل والرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي وشركائهم.
وهذا الأمر ضروري، من جهة لأن قرارات إدارة الأزمات تلك سيجري من خلالها إيجاد الواقع الدستوري للاتحاد الأوروبي مستقبلا، ومن جهة أخرى، لأن الأمر لن يكون سهلا على الإطلاق، فالتصويت ب "لا" على مسار الإنقاذ من قبل مجتمع متحد يمكنه أن يسبب تشويشا بسهولة، ويؤدي إلى الخلط بينه وبين الشعبوية المشككة باليورو التي تنتشر حاليا في هذا المجتمع المتحد بالذات. وسيجد هؤلاء المحللون المضللون في صحيفة التابلويد الألمانية الشهيرة "بيلد" ما يمكن تسميته ب"جهازهم المركزي"، ولن يبقى أمامهم إلا إيجاد حزب سياسي للإنطواء في صفوفه.
وما هو على المحك لا يقل أهمية عن ذلك: إما ان تحل أزمة اليورو من "الأعلى" من خلال فرض نظام من التقشف الشديد في الاتحاد الأوروبي، مما سيحد من مجال المناورة لواضعي السياسات على الأرض، ويعزز القوى الاجتماعية الرافضة للمثال الأوروبي، وإما أن تحل أزمة اليورو بضغوط من "الأسفل" الأمر الذي سيجبر الحكومات الأوروبية على تصحيح مسارها.
ولا تكفي حملة لافتات للنقابات العمالية لتحقيق ذلك. فلا يوجد أزمة استدعت "التأثيرات المنتجة الإيجابية" من خلال النداءات فقط، بل كانت دوما تحتاج، كما يذكرنا المؤرخ كوكا، إلى نقد الرأسمالية وإلى التزام سياسي وتعبئة اجتماعية، والانتقاد قد انتشر على صفحات الجرائد، لكن الإدراك بأن هذا سيتطلب المزيد من العمل، ما زال يكتنفه الغموض.
بحسب استطلاعات الرأي الأخيرة، فان ثلثي مواطني الاتحاد الأوروبي يعتقدون بان السوق الموحدة قد عادت بالنفع على الشركات الكبرى فقط، في حين نصفهم يعتقد بأن الوضع الراهن الأوروبي انتقص من ظروف العمل، وبان الوضع الحالي من الاندماج السياسي لا يفيد المحرومين بشيء. وهذا يقول الكثير عن طبيعة أوروبا التي تريد المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل وغيرها إنقاذها. ولكن يبقى من الخطأ التخلي عن هذه الفكرة بسرعة وترك الميدان لأولئك الذين يرون المخرج من الأزمة عبر إعادة المارك وتفكك التضامن والانغلاق القومي.
FX-Arabia
|
|
جديد المواضيع |

لوحة التحكم
روابط هامة
|
||||||
| منتدى الاخبار و التحليل الاساسى تعرض فيه الاخبار المتجددة لحظيا و التحليل الاساسى و تحليلات الشركات المختلفة للاسواق, اخبار فوركس,اخبار السوق,بلومبيرج,رويترز,تحليلات فوركس ، تحليل فنى ، اخر اخبار الفوركس ، اخبار الدولار ، اخبار اليورو ، افضل موقع تحليل ، اخبار السوق ، اخبار البورصة ، اخبار الفوركس ، اخبار العملات ، تحليلات فنية يومية ، تحليل يورو دولار |
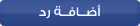 |
|
|
أدوات الموضوع |
|
|
المشاركة رقم: 1 | ||||||||||||||||||||||||||
|
المنتدى :
منتدى الاخبار و التحليل الاساسى
يواجه الاتحاد الأوروبي مستقبلا محفوفا بالمخاطر إذا استمر القادة الأوروبيون في استرضاء المصارف من خلال فرض إجراءات تقشفية، فالأزمات الكبيرة للرأسمالية، كانت في الغالب، حسبما يقول المؤرخ الاجتماعي الشهير "جرجن كوكا" محفزات لإصلاح عميق للرأسمالية نفسها، وهذا التحليل يمكن أن يشكل أملا بإيجاد مخرج من الأزمة، وفي الوقت نفسه، ينبغي أن يشكل تحذيرا، فإذا كانت أزمة اليورو تقدم فرصا للخروج بــ «تأثيرات منتجة إيجابية»، فلا بد من اغتنامها الآن |
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
#1
|
|
|
|
|
يواجه الاتحاد الأوروبي مستقبلا محفوفا بالمخاطر إذا استمر القادة الأوروبيون في استرضاء المصارف من خلال فرض إجراءات تقشفية، فالأزمات الكبيرة للرأسمالية، كانت في الغالب، حسبما يقول المؤرخ الاجتماعي الشهير "جرجن كوكا" محفزات لإصلاح عميق للرأسمالية نفسها، وهذا التحليل يمكن أن يشكل أملا بإيجاد مخرج من الأزمة، وفي الوقت نفسه، ينبغي أن يشكل تحذيرا، فإذا كانت أزمة اليورو تقدم فرصا للخروج بــ «تأثيرات منتجة إيجابية»، فلا بد من اغتنامها الآن وكانت الأزمات السابقة قد مهدت الطريق أمام تغيرات بنيوية، أو على أقل تقدير، ساهمت في تسريع وتيرة هذه التغيرات. كما ساهمت الأزمات بتنظيم مؤسسات الدولة، ودولة الرفاه بالذات، وليس أقله النموذج الاقتصادي الكينزي الذي هيمن لفترة طويلة على النهج الاقتصادي. وكانت هذه الصورة الأكبر، لكن، في النهاية، انفصلت " التأثيرات الإيجابية المنتجة " مجددا عن مجموعة المصالح القوية، وتم التضييق عليها في ألمانيا من قبل ائتلاف الحزبين الديمقراطي الاشتراكي والخضر، الذي ألغى الأنظمة القائمة وتخلى عن مستوى توزيع الدخل الذي أمكن تحقيقه، مما شكل أحد أسباب الصدمة الاقتصادية الحالية. فهل تم استيعاب دروس أزمة الدين في أوروبا؟ لا يبدو ذلك. فما يجري تمريره للجمهور الأوروبي باعتباره شكل لإدارة الأزمة لا علاقة له ب "التأثيرات المنتجة الإيجابية" التي تحدث عنها كوكا، وبدلا من إيجاد حل لأسباب الأزمة الاقتصادية والسياسية، فإن هذه الأسباب يجري التعامل معها على أنها هي الحل، وما تبقى للدولة من دور منذ عام 2008، يتلخص في تحمل الأعباء الاجتماعية لتلك الأزمة المالية العائدة للقطاع الخاص. وما ان أصبحت الميزانيات العامة تنوء تحت وطأة كلفة توالد الثروات الخاصة، حتى تم صرف وصفة جديدة للشفاء من المرض الذي بات يدعى الآن "أزمة الدولة ومع انتشار الأزمة، انتقل المبدأ الألماني القاضي "بكبح الدين" إلى أوروبا. لكن هل هذا بفضل فضائل ربة المنزل المقتصدة كما تدعي المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل؟ لا بتاتا، وميركل تقول: "ما يتوجب عدم القيام به هو تدمير ثقة المستثمرين، فيما نحن نسعى إلى إيجاد حلول"، وهذا يكشف عن ولائها، ويوضح المستوى الذي وصل إليه الجدال الأوروبي، حيث بات يقتصر على توفير المال والمحافظة على حق المطالبة بالديون وعلى التنافسية، وعندما تجري المطالبة بمزيد من «العاطفة تجاه أوروبا»، ينحسر الجدل في الدعوة إلى عقوبة ضبط الميزانيات، وسن قوانين لسداد الديون السيادية، وغيرها. وكل هذا لا يمكنه إخفاء المشاحنات ذات الأبعاد السياسية للائتلاف الحاكم في ألمانيا حيال السياسة الأوروبية. والحديث عن أن البرلمان في المستقبل سيصبح على علاقة وثيقة بالقرارات المتعلقة بإنقاذ اليورو، لا يشكل بحد ذاته جوابا على السؤال حول ماذا سيقوم النواب بإنقاذه أصلا. أخيرا، أعلنت المستشارة الألمانية: «إذا فشل اليورو، فشلت أوروبا». والجملة في افضل الأحوال تعبر عن نصف الحقيقة، لان الأسس التي قامت عليها أوروبا بشكلها الأفضل قد تم تدميرها، فأوروبا التي كانت في نزاع حول معاهدة لشبونة، كانت على الأقل مفتوحة للنقاش، كانت تقف إلى جانب المعايير الاجتماعية والحقوق الأساسية القابلة للتنفيذ. ومن يريد إنقاذ أوروبا، وفي ذهنه اكثر من مجرد مشروع نخبوي من منطلق مصلحة اقتصادية لا غير، يصاحبها بالتأكيد عجز ديمقراطي ومنافسة ضريبية وإغراق بالعمالة الرخيصة، يتوجب عليه ان يقف الآن للدفاع عن نفسه ضد هجمات المنقذين أمثال المستشارة ميركل والرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي وشركائهم. وهذا الأمر ضروري، من جهة لأن قرارات إدارة الأزمات تلك سيجري من خلالها إيجاد الواقع الدستوري للاتحاد الأوروبي مستقبلا، ومن جهة أخرى، لأن الأمر لن يكون سهلا على الإطلاق، فالتصويت ب "لا" على مسار الإنقاذ من قبل مجتمع متحد يمكنه أن يسبب تشويشا بسهولة، ويؤدي إلى الخلط بينه وبين الشعبوية المشككة باليورو التي تنتشر حاليا في هذا المجتمع المتحد بالذات. وسيجد هؤلاء المحللون المضللون في صحيفة التابلويد الألمانية الشهيرة "بيلد" ما يمكن تسميته ب"جهازهم المركزي"، ولن يبقى أمامهم إلا إيجاد حزب سياسي للإنطواء في صفوفه. وما هو على المحك لا يقل أهمية عن ذلك: إما ان تحل أزمة اليورو من "الأعلى" من خلال فرض نظام من التقشف الشديد في الاتحاد الأوروبي، مما سيحد من مجال المناورة لواضعي السياسات على الأرض، ويعزز القوى الاجتماعية الرافضة للمثال الأوروبي، وإما أن تحل أزمة اليورو بضغوط من "الأسفل" الأمر الذي سيجبر الحكومات الأوروبية على تصحيح مسارها. ولا تكفي حملة لافتات للنقابات العمالية لتحقيق ذلك. فلا يوجد أزمة استدعت "التأثيرات المنتجة الإيجابية" من خلال النداءات فقط، بل كانت دوما تحتاج، كما يذكرنا المؤرخ كوكا، إلى نقد الرأسمالية وإلى التزام سياسي وتعبئة اجتماعية، والانتقاد قد انتشر على صفحات الجرائد، لكن الإدراك بأن هذا سيتطلب المزيد من العمل، ما زال يكتنفه الغموض. بحسب استطلاعات الرأي الأخيرة، فان ثلثي مواطني الاتحاد الأوروبي يعتقدون بان السوق الموحدة قد عادت بالنفع على الشركات الكبرى فقط، في حين نصفهم يعتقد بأن الوضع الراهن الأوروبي انتقص من ظروف العمل، وبان الوضع الحالي من الاندماج السياسي لا يفيد المحرومين بشيء. وهذا يقول الكثير عن طبيعة أوروبا التي تريد المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل وغيرها إنقاذها. ولكن يبقى من الخطأ التخلي عن هذه الفكرة بسرعة وترك الميدان لأولئك الذين يرون المخرج من الأزمة عبر إعادة المارك وتفكك التضامن والانغلاق القومي. |
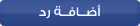 |
| مواقع النشر (المفضلة) |
| الكلمات الدلالية (Tags) |
| الأوروبية, الديون, استيعابها, دروس |
|
|
الساعة الآن 12:44 AM












